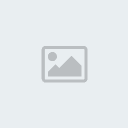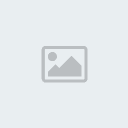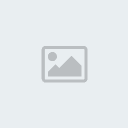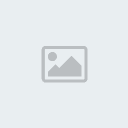الكاتب: د/ عفت محمدالشرقاوى
أثارت
في بعض الآثار الحديثة جدلاً شديداً حول ترجمة القرآن، وإذا كان الاسلام
قادراً ـ بما تتضمن نصوصه من حق الاجتهاد في التشريع على التكيف لكل ما
يجد على المجتمع في حدود الإطار العام لمبادئ الدين الأصلية.. وإذا كانت
نصوص القرآن تؤكد صلاحية الاسلام لكل عصر بما تتضمن من قيم عليا ومثل
رفيعة لا تنافى المدنية الحاضرة المتفق عليها عند الأمم المرتقية كما يقول
المفسر المحدث، فإن كل هذا قد يحتم على المسلمين أن يقوموا بكتابة ترجمة
تفسيرية للقرآن أو لمعانيه إلى لغات العالم.
ولم يكن من
حسن التوفيق أن يتصدى المسؤولون في تركيا الحديثة خاصة للترويج للترجمة،
فقد عدّ هذا منهم محاولة لإضعاف الأمة العربية ولمعاداتها، ولتفضيل لغة
أبناء جنسهم على لغة كتاب ربهم وسنة رسوله، ثم التمهيد بذلك للمروق من
الاسلام، على حين رأى بعض الباحثين فيها بدعة يدفع إليها التهور الشديد.
وقبل أن نستمر في تصوير أبعاد هذه المشكلة التي أثارت جدلاً ونزاعاً في
التفسير الحديث يحسن بنا أن نوضح أن الترجمة المعنوية التي هي عبارة عن
تفسير ما يحتاج إلى تفسيره بلغة أخرى، غير محرمة، وإنما تتبع فيه المصلحة
الشرعية بقدرها.
يعترف المنار بأن من تقصير المسلمين في
نشر دينهم ألا يبينوا معاني القرآن لأهل كل لغة بلغتهم، ولو بترجمة بعضه،
وهو يقصد بالترجمة هنا المعنوية التفسيرية لا اللفظية الحرفية ولكنه يحظر
ترجمة القرآن لأن ترجمة القرآن ترجمة حرفية تطابق الأصل متعذرة والترجمة
المعنوية ليست إلا بياناً عن فهم المترجم للقرآن، وحينئذ لا تكون هذه
الترجمة هي القرآن، وإنما هي فهم رجل للقرآن يخطئ ويصيب.
إن
تفسير القرآن علم قائم بذاته يشرح معناه ويوضح غريبه ويبين محكمه
ومتشابهه، وناسخه ومنسوخه، وأحكامه مع مقارنة الآيات والقصص المتكررة
وتوجيهها وبلاغة تكريرها، ثم يذكر سبب نزول الآيات والحكمة في ترتيبها
وترتيب سور القرآن، ولماذا وضعت هذه الآية قبل هذه ووجه الارتباط بينهما
ومناسبة مجيء سورة آل عمران بعد سورة البقرة وسورة النساء بعدها وهلم
جراً، وما دام المطلوب في الترجمة لا يتضمن كل هذا في رأي المعارضين فإن
المقصود حينئذ ترجمة القرآن لا ترجمة معانيه، مهما يزعم المؤيدون بأنهم
إنما يقصدون إلى ترجمة معاني القرآن.
هذا الاختلاف الواضح
حول المقصود، باصطلاح ترجمة معاني القرآن وهو الاصطلاح الأكثر شيوعاً ـ
ينتهي إلى تحديد حاسم في فتوى العلماء. ففي الشروط التي وضعتها لجنة كبار
العلماء لجواز الترجمة ما يفسر المقصود بالترجمة على الوجه الذي ترضاه، قد
أفتت اللجنة بأن فهم معاني القرآن الكريم بواسطة رجال من خيرة علماء
الأزهر الشريف بعد الرجوع لآراء أئمة المفسرين وصوغ هذه المعاني بعبارات
دقيقة محددة ثم نقل المعاني التي فهمها العلماء إلى اللغات بواسطة رجال
موثوق بأمانتهم واقتدارهم في تلك اللغات، بحيث يكون ما يفهم في تلك اللغات
من المعاني، هو ما تؤديه العبارات العربية التي يضعها العلماء ـ جائز
شرعاً ـ بشرط أن يوضع تعريف شامل يتضمن أن الترجمة ليست قرآناً وليس لها
خصائص القرآن، وليست هي ترجمة كل المعاني التي فهمها العلماء، وأن يطبع
التفسير المذكور بجوار الترجمة المذكورة.
كان في مصر
دعايتان تذكران لترويج الترجمة، دعاية للأستاذ فريد وجدي، وأخرى للشيخ
محمد مصطفى المراغي، والفرق بين الدعايتين أن الأستاذ فريد وجدي تكلم
بلسان جديد وبنى دعايته على شبه عصرية اجتماعية وسياسية، وأن الشيخ
المراغي يضيف إلى ذلك إلماماً بأقوال الفقهاء في ترويج ما دعا له، وإن
خالفهم في مقاصدهم واتفق مع الأستاذ فريد في مغزاه، كما يدعي المعارضون.
وسنلخص فيما يلي حججهما في مسألة الترجمة كما أوردها أحد الباحثين ثم نعود إلى آراء المعارضين.
اعتمدت الدعاية العلمية في مصر لمسألة الترجمة على الحجج الآتية:
1 ـ قول الإمام أبي حنيفة في جواز القراءة بالفارسي لغير القادر على العربية.
2 ـ تفريق المتكلمين بين الكلام اللفظي والكلام النفسي، عند قولهم بأن القرآن كلام الله غير مخلوق.
3 ـ ادعاء المجددين أهمية فهم القارئ معنى ما يقرؤه في الصلاة.
4 ـ ضرورة تمثيل القرآن بنصوصه المترجمة أمام الشعوب المسلمة من غير العرب، ليكونوا على بينة من كتابهم، في
عصر تكافح فيه الأديان والمذاهب، وتحريم الترجمة يعد جبناً وفراراً بكتاب الاسلام عن ساحة المقايسة بالكتب.
5 ـ حبس القرآن في الدائرة العربية ينافي كونه ديناً عاماً، ويؤيد شبهة الذين يدعون اختصاصه بالعرب.
فأما
المسألة الأولى وهي القراءة بالفارسية في الصلاة، فإنها إحدى الحجج
الفقهية التي ساقها مؤيدو الترجمة، ذلك أن جميع الأئمة على وجوب القراءة
بالقرآن للعربي، فأما الأعجمي العاجز عنها فإنه يسكت ولا يقرأ شيئاً، إلا
أبا حنيفة فإنه رأى ألا يسكت ويقرأ بلغته مترجماً. وذهب مؤيدو الترجمة إلى
القياس في ذلك فقالوا: ما دام أبو حنيفة أجاز القراءة بالأعجمية في الصلاة
ففي غيرها من باب أولى، ورد المعارضون بأن مذهبه ينص على منع ترجمة القرآن
كله، ومسألة القراءة في الصلاة جزئية صغيرة، لا تعلق لها بحكم القرآن في
مجموعة وفي شكله وفي تلاوته.
هذا إلى أنه قد صح رجوع الإمام
إلى آراء أئمة المسلمين في القادر، فأما العاجز فإن آية قصيرة مثل
(مدهامتان) تصح بها الصلاة على مذهب أبي حنيفة نفسه وقد رجح فضيلة الشيخ
المراغي وجوب الصلاة بترجمة القرآن للعاجز عن قراءة النظم العربي.
وأما ما قيل من أن الترجمة ليست قرآناً وما كان كذلك كان من كلام الناس
فهو غير صحيح في رأيه، لأن الترجمة وإن كانت غير قرآن باتفاق، فإنها تحمل
معاني كلام الله. ومعاني كلام الله ليست كلام الناس، وعجيب أن تسلب من
معاني القرآن صفاتها وجمالها وتوصف بأنها من جنس كلام الناس، بمجرد أن
تلبس ثوباً آخر غير الثوب العربي كأن هذا الثوب هو كل شيء.
وقد أخذ عليه الاستخفاف بنظم القرآن بعد أن ثبت التساوي بين لفظ القرآن
ومعناه في القداسة، والنسبة إلى الله تعالى، وهو الذي أنزله بلفظه ومعناه،
فاختار لفظه من بين الألفاظ، ومعناه من بين المعاني.
أما
على نظر المتكلمين الأشاعرة القائلين بالكلام النفسي القديم، فليس المراد
أن المعنى القرآني قديم، ولفظه حادث، وليس هذا إلا غلطاً ممن ظن أن معنى
لفظه ومدلولاته هو ذلك الكلام النفسي القديم، وأنه صفة الله القائمة
بذاته، فتوهم للمعنى مزية على اللفظ في النسبة لله تعالى، والحال أن معنى
القرآن ولفظه سيان، في كون كل منهما أثر صفة الكلام القديمة لا نفس تلك
الصفة، وأن الفرق الذي يرى في كلامهم، يجعل الكلام اللفظي دون غيره من حيث
الحدوث والقدم، فإنما هو بالنسبة إلى الكلام النفسي الذي يراد به صفة
الكلام، لا بالنسبة إلى المعنى الذي هو مدلول اللفظ.
هذه
أطراف عامة من الجدل الفقهي والكلامي الذي ثار حول مسألة الترجمة، وفي
اعتقادي أنه لم يكن ثمة ما يدعو إليه، لو التزم الجانبان الحد الواضح،
الذي وعته لجنة كبار العلماء، وهي الفتوى التي لا أعتقد أن أحداً من
الجانبين يزعم الخروج عليها، حيث تكون الترجمة ترجمة للتفسير، وينص فيها
على أنها ليست قرآناً وليس لها خصائص القرآن وإنما هي ترجمة لبعض المعاني
التي فهمها العلماء، وفي مثل هذا التحديد الحاسم الذي قررته لجنة الإفتاء،
لا تقوم قضية الصلاة بالترجمة ولا ينشأ الجدل حول الكلام اللفظي والكلام
النفسي، فإن ترجمة التفسير، لا يختلف عليها أحد، ولا هي مما يثير كل هذا
الجدل الفقهي والكلامي.
أما مسألة ادعاء المجددين أهمية
فهم القارئ معنى ما يقرؤه في الصلاة، فإنها مما يبدو فيه الزعم بترجمة
القرآن نفسه واضحاً، مثل قول فريد وجدي: ((ومن العبث مناجاة الله بلغة غير
مفهومة فيتعين على العاجز عن العربية أن يترجم القرآن وأن يصلي به ليتحقق
منه معنى الصلاة، وإلا كان عمله عبثاً محضاً))، فالأستاذ يسوي هنا بين
تعلم قراءة القرآن العربي، بقدر ما تجوز به الصلاة، أو تفهم معنى هذا
القدر منه، وبين تعلم لغة العرب بتمامها، وفي هذا مغالطة واضحة أخذها عليه
المعارضون، حين أوضحوا أن المنع عن ترجمة القرآن، وإقامة المترجم مقام
الأصل ليس بافتراض تعلم لغة العرب، على الشعوب المسلمة من غير العرب
وإرهاقهم بالتعرب، وإنما المفروض أن يتعلموا من القرآن العربي ما يسر لهم
لأداء فريضة الصلاة.
وأما ما يثيره مروجو الترجمة من ضرورة
تمثيل القرآن بنصوصه المترجمة أمام الشعوب المسلمة من غير العرب، وما يقال
من أن تحريم الترجمة والأخذ بالتراجم يعد جبناً وفراراً بالاسلام عن ساحة
المقايسة بالكتب، وأن حبس القرآن في الدائرة العربية ينافي كونه ديناً
عاماً، فإن المعارضين يكشفون في الرد على ذلك عن موقف الاسلام الحر
الممتاز بحريته على الأديان ويتساءلون: ((أي دين منح الباحثين في عقائده،
وأحكامه، وحرية الوزن بميزان العقل، كما منح دين الاسلام؟))، فأما ترجمة
القرآن فإنها في نظرهم مسألة أخرى ترمي إلى إنساء القرآن في تلك البلاد
على الأقل، وإدخال الشبهة فيما يتداول باسمه على لغات وأساليب شتى. على
أنه من المعروف أن فهم معاني القرآن لغير العرب مفتوح الباب، فإن دين
الاسلام عام بالرغم من عربية القرآن، ((فخصوص لغة القرآن لا ينافي عموم
دين الاسلام)) فكلاهما أمر ثابت معروف.
وبعد، فإن أدق
مسألة في قضية الترجمة في رأيي هي مسألة تعذر ترجمة القرآن، فالكلام فيها
كلام في المستحيل، قبل أن يكون كلاماً في الجائز والمحرم، لأن ترجمة
القرآن ((لا يمكن أن تقوم مقام الأصل في تحصيل كل ما يقصد به... وفيها
إهدار لنظم القرآن، وإخلال بمعناه، وانتهاك لحرماته وهو فعل لا تدعو إليه
ضرورة))، ومن الثابت أن القرآن يتضمن كثيراً من المعاني والإرشادات
الدقيقة التي لا سبيل إلى ترجمتها، ولذلك فإن ما نجده منقولاً إلى لغة غير
العربية، لا يعتبر قرآناً ولكنه تفسير، وقد فطن إلى هذه الحقيقة، ونبه
إليها صاحب أدق ترجمة لمعاني القرآن الكريم، وهو الإنجليزي المسلم (محمد
بيكتول) الذي يقرر في مقدمتها أن القرآن لا يمكن ترجمته، وأن الترجمة التي
يقدمها ليست هي القرآن الكريم وإنما هي محاولة لتقديم بعض معانيه باللغة
الإنجليزية وهي لذلك لا يمكن أن تحل في الفهم والشرح محل القرآن نفسه.
ولقد
صور المنار حقيقة التعذر التي تواجه الترجمة، وفصل القول في استحالة ترجمة
المفردات، فلا يمكن أن تتفق لغتان من لغات العالم في جميع مفرداتها، ولذلك
ذهب بعض علماء اللغات وعلماء الاجتماع إلى استحالة قيام لغة مقام أخرى،
وقد أورد مثالاً على ذلك الأسماء الموضوعة ليوم القيامة وهي كثيرة، وكل
لفظ منها له معنى تدل عليه مادته العربية، وذكر من مفردات الأفعال دلالة
صيغها من حيث التكلف والتكثير والمشاركة والمطاوعة، ومن مفردات حروف
المعاني والأدوات الفرق في العطف بين الواو والفاء وثم وبين الحصر بإنما
والحصر بحر في النفي والإثبات... وغير ذلك كثير. أما في الجمل فقد أشار
رشيد رضا إلى الجملة المقيدة بالحال، والفرق فيها بين الحال المفردة وجملة
الحال وما يترتب على ذلك من آثار شرعية، وأوضح أنه أظهر وجوه الإعجاز
اللفظية، وعرض لنموذج من ترجمة تركية فنقده بما يدل على أن ترجمة القرآن
ضرب من المستحيل.
إن استبدال كلمة واحدة بأخرى مرادفة،
يفقد النص جانباً من أصالته وإعجازه مهما يبد من التشابه بين الكلمتين
المتبادلتين. ولقد ينفرد اللفظ بإيحاء فلا يمكن أن يؤديه لفظ آخر. وفضلاً
عن ذلك فإن أي نص أدبي من صنع البشر ليس مجموعة من الأفكار متميزة عن
ردائها اللغوي. وإذا كان من الجائز أن نميز بين الأفكار واللغة في مجالات
العلوم مثلاً، فإننا أمام النص الأدبي الرفيع نستشعر العلاقة الوثيقة بين
الأفكار واللغة ((إذ يبدو أن اللغة هي التي أنتجت بنشاطها أو فاعليتها
الخاصة هذه الأفكار، فالذي يخرج الأفكار من النص الأدبي العادي، يكشف عن
بعد خاص للنص الأدبي، ولكنه لا يربط هذه الأفكار باللغة مع أنهما شيء واحد
وفي ترجمة العمل الأدبي العادي يعمد المترجم إلى تصور فكري عام لمضمون
النص مستيعناً بمعجم لغوي، وبهذا يتجاهل القيمة اللا معجمية للفظ متناسياً
أن ((الكثرة الغالبة من الألفاظ مثقلة بأشياء غير الفكرة التي تحملها،
فإلى جانب الأفكار، هناك ما لا يقع تحت حصر من المشاعر والصور فليست
اللفظة إذن رمزاً يشير إلى فكرة ومعنى فحسب، بل هي نسيج متشعب من صور
ومشاعر أنتجتها التجربة الانسانية وثبتت في اللفظة فزادت معناها خصباً
وحياة)).
وإذا كانت الترجمة أمراً لا يدرك ولا يرام ـ
لأنها مما يستحيل على البشر فيما يتعلق بكلام الله المعجز ـ فإن ترجمة
تفسير القرآن أو ما يفهمه المفسر من معانيه ضرورة واجبة، لأن المسلمين إذا
أهملوا ذلك أصبحوا في كثير من بقاع الأرض ((قوماً لا سن6 لهم، ولا مرجع،
يجدون بين أيديهم مصحفاً يتبركون بورقه ويلثمون غلافه، ويضعونه على الرأس
والعين احتراماً له، ولكنهم لا يفهمون ما فيه، والكتاب الذي غير مجرى
التاريخ، وعرف العالم مبادئ الخير والصلاح، ستصبح معانيه مغلقة على كثير
من الأمم، وهذا إسراف في الجور، لا يتفق وسماحة الدين الاسلامي الذي جاء
به محمد رسول رب المشرقين والمغربين (ص) إلى كافة الناس)).
ومن جهة أخرى فإن التوقف عن ترجمة تفسير لمعاني القرآن سوف يتيح الفرصة
لانتشار ترجمات فاسدة كتبها حانقون على الاسلام وربما دل سكوتنا عن تقديم
مثل هذه الترجمة على اقتناعنا بصحة هذه الترجمات في نظر كثير من
الأوروبيين.
ويمكن تقسيم الترجمات التي ظهرت للقرآن حتى
الآن إلى ترجمات كتبها مستشرقون وترجمات كتبها القاديانيون وترجمات كتبها
المسلمون.
وترجع أول ترجمة للقرآن كتبها المستشرقون إلى
القرن الثاني عشر الميلادي. فقد كتب أحد الرهبان ترجمة لمعاني القرآن
باللغة اللاتينية سنة 1143م وتبع ذلك ترجمة لاتينة أخرى سنة 1668م، ثم
توالت الترجمات بعد ذلك، وكان من أشهرها ترجمة جورج سيل سنة 1734م، وهي
ترجمة تبدو أكثر أمانة مما سبقها من الترجمات، على الرغم مما بها من
المآخذ التي تدل على كراهية المترجم للاسلام وكتابه الكريم، وغيرها.
هذا ما كان من شأن ترجمات المستشرقون، أما الترجمات التي كتبها
القاديانيون سواء منهم الفرع الذي يؤمن بالمتنبى غلام أحمد القادياني
مجدداً للشريعة الاسلامية، أم الفرع الذي يؤمن بالمتنبى القادياني نبياً
أوحى إليه، فقد قامت على تأويلات شاذة تتعارض مع وجهة النظر الاسلامية في
كثير من العقائد، وتتضمن كثيراً من الآراء الفاسدة التي لا يقرها الاسلام.
وأما
الترجمات التي كتبها المسلمون، فإن أشهرها ترجمة بيكتول، وقد طبعت في لندن
عام 1930، ولعلها أول ترجمة قام بها مسلم من أهل السنة، صحيح العقيدة
إنجليزي الأصل. ويعتقد بيكتول أن محاولته تمتاز بأنها تقدم للقارئ
الإنجليزي ـ قدر المستطاع ـ ما يعتقد المسلمون في أنحاء العالم بأنه من
معاني القرآن. ذلك ان غير المؤمن بالدين ورسالته لا يستطيع تقديم كتاب هذا
الدين للناس بأمانة كافية. ومن هنا كانت أهمية ترجمة بيكتول من حيث أنها
أول ترجمة إنجليزية يقدمها إنجليزي مسلم.
على أن كثيراً من
الترجمات التي أشرنا إليها يدعى صراحة أنه ترجمة للقرآن، وقليل منها ينص
على أنه ترجمة لمعانيه فحسب، كما فعل المترجمون المسلمون، وكما فعل
المستشرق أربري الذي سمى ترجمته لمعاني القرآن: ((القرآن مفسراً)).
ومن المحقق أن هناك ترجمات كثيرة للقرآن في العالم، ولقد ذكر بعض الباحثين
أن عدد اللغات التي ترجمت إليها معاني القرآن الكريم قد يبلغ ثمانين لغة.
على أن كثيراً من هذه الترجمات قد كتب رغبة في إملاء نظريات خاصة في تفسير
الاسلام ونشأته، ومن هنا كانت إساءة هذه الترجمة أكثر من إفادتها، فقد
شوهت صورة الاسلام في عقول كثير من الأوربيين الذين رغبوا في فهم الاسلام
من كتابه الخالد مستعينين بهذه الترجمة فحين يتطلع الأوربي المثقف إلى
معرفة بعض معاني القرآن الكريم، لا يجد ما يسعفه إلا هذه الترجمات التي
كتب كثير منها بقصد الدعاية ضد الاسلام.
لذلك فقد أحسن
المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية صنعا حين اتجه إلى كتابة تفسير باللغة
العربية، ينقل بعد ذلك إلى اللغات الأوربية وإلى لغات المسلمين على
اختلافها، بعد أن رأى أن تبليغ هذا القرآن للناس أمر لا مناص منه، وأن
الترجمة منال لا يدرك ولا يرام.
=====================
المصدر: الفكر الديني في مواجهة العصر

موقع هدي الإسلام